- إنضم
- 14 يناير 2022
- رقم العضوية
- 12560
- المشاركات
- 562
- مستوى التفاعل
- 1,652
- النقاط
- 272
- أوسمتــي
- 4
- توناتي
- 245
- الجنس
- ذكر
LV
1
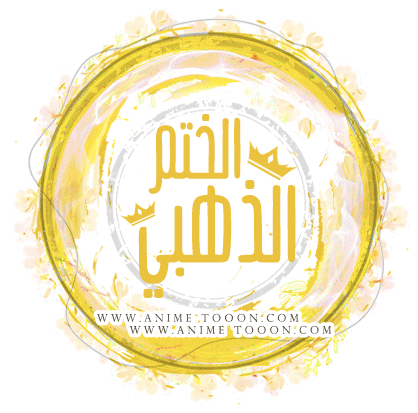
منزل يعيش فيه شقيقان: عبدالواحد وفضيلة. إنهما يودّان بعضهما البعض في صورة تعكس القالِب الأحسن من صلة الرحم الوثيقة. أمهما وأبوهما، المتحابان، عززا صلة الدم البيولوجية بصلة الصداقة الحقة فكانت النتيجة: شقيق يحب ويحترم شقيقته، وشقيقة تحب وتحترم شقيقها. كان الأول بيت أسرار للثاني.
كثيراً ما كان عبدالواحد يقول لفضيلة: إن جار الزمان عليّ، فلن يخلصني في هذا العالم أحدٌ غيركِ.
فترد عليه فضيلة بابتسامة مشرقة: أنا وأنت سواء في هذا الأمر يا عزيزي.
ما ينطبق على عبدالواحد وفضيلة لا ينطبق على بعض الأخوة والأخوات في هذا العالم. المنزل المجاور مثال حي على ذلك. هذه المعاني من جملة: الحب، الاحترام، الحَنْو، الإيثار لم يعرفها أبداً الشقيقان رائد وعبدالعزيز. دائماً ما يصل ضجيجهما الناجم عن عراك لفظي وبدني إلى مسامع الجيران. رائد وعبدالعزيز عداوتهما ليست صُدْفة، بل كانت بذوراً سامة نشأت في تربة مراهقتهما. وساهم في نمو هذا الشقاق لا مبالاة الأبوّين في احتواء الابنين وحمل الأول على حُب الثاني. زوج لا يحب زوجته، وزوجة لا تحب زوجها يساوي أب وأم غير مغرمين بابنيهما. الحاصل، وكنتيجة لهذا الخراب جاءت ذريتهما: رائد يبغض عبدالعزيز، والعكس صحيح. نتيجة هذا البُغْض القديم، كَبُرَ هذا الشقاق وأصبح بركاناً وسعيراً في حالة الحرب وصفيحاً بارداً مثلجاً ليس فيه وُدّ في حالة السِلْم.
ذات ليلة رائقة النسيم، كان عبدالواحد وفضيلة يجلسان في غرفة الجلوس. ودار بينهما هذا الحوار اللطيف:
- فضيلة، ما هذا الكتاب الذي بين يديكِ؟
- كتاب عن الكون.
- إذن ما رأيكِ أن نجلس في الفناء ونرقب سماء الليل.
- موافقة. ولكن اسبقني إلى الفناء ريثما أهيئ الشاي والكعك.
- نعم الرأي!
ذهب عبدالواحد إلى الفناء، وذهبت فضيلة إلى المطبخ. بعد قليل، لحقت فضيلة بأخيها لكنها وجدته أصغر من أضأل فأر من فئران المنازل.
كان كلامهما بكاء وصيحات جزع. بعد أن استوعب كلٌ منهما جرعة الصدمة، مدت فضيلة يديها برفق إليه وقالت بحنان أخت وقلب أم: "ارْتقِ إلى يديّ، ليس من الأمان البقاء في الفناء"، وتابعت بنبرة مذعورة وهي تشير إلى ركن بعيد، "في الأمسِ رأيتُ بُومَة هناك."
الرؤى الجديدة دائما ما تكون نافذة على اختبار مشاعر جديدة. نما شعور غريب إلى نفس عبدالواحد وهو جالس على يديّ أخته وكأنه على متن طائرة. كان ينظر إلى الأشياء من منظور جَوِّيّ. وحينما هبط إلى الأرض، كل شيء كان يبدو أكبر وأبعد. السقف كأنه السماء، والسجاد الذي تحته كأنه عُشْب مَجْزُوز لملعب كرة قدم كبير. المَنارة المعلقة في السقف وتحوي خمسة مصابيح كأنها خمسة شُمُوس، الأرائك كأنها منازل مرصوفة، طاولة القهوة في المنتصف كأنها برج. أخبر عبدالواحد أخته عن شعوره بالأشياء لأول مرة وهو في حجمه الحالي. تفطر قلبها لحاله وطلبت منه الصبر؛ إذ ربما تزول الحالة الغرائبية التي أصابته من تلقاء نفسها بعد فترة وجيزة.
بعد ذلك، فكرت فضيلة في نفسها: أين أضع أخي عندما يحين وقت النوم؟ أريد أن أضعه في غرفة آمنة لا تأتي إليها وزغة أو فأرة أو حشرة فرّسية. منزلنا نظيف، أعرف هذا. ولكن من يعرف ما قد يحصل: ربما يأتينا ضيوف غير مرغوب فيهم ويمسون أخي الحبيب بسوء. وجدتها! سأضعه في المكتبة. إنه أئمن مكان.
لقد اختارت فضيلة المكان الأكثر قيمة إليها، وهي غرفة المكتبة، لأعز إنسان إلى قلبها وهو شقيقها. من باب الحيطة والحذر وضعته على طاولة الكمبيوتر في مجسم لمنزل تحوطه حديقة: الشجر والزهرات مصنوعة من الورق المقوى. رفع عبدالواحد رأسه ونظر إلى رفوف الكتب والمجلدات طابقاً طابقاً يتأملهم. وهناك أيضاً مجسم كرة أرضية وخريطة جغرافية للعالم. كل ما يحتاجه الأديب، المثقف، الفنان، محب العلم، يقبع في هذه المكتبة.
تجول عبدالواحد في الحديقة اليَدَوِيّة قائلاً: ليس ثمة هنا عبيق.
ضحكت فضيلة: عندما تعود إلى أصلك، عندئذ سوف آخذك إلى حديقة غنّاء فيها العندليب والورود وضحكات الأطفال.
- أتعرفين يا فضيلة، أريد التجول في أنحاء الدار ما دمتُ أنا اليوم غيري في الأمس.
- في الحال عزيزي.
أول مكان طلب عبدالواحد من أخته فضيلة اصطحابه إليه هو المطبخ. أراد أن يعيش في نفس أجواء القصة التي قرأها: سَامٌ والفَاصُوليَة. مشى الشاب على سطح دولاب المطبخ ووجد القدور كأنها غرف ضخمة مكتنزة الحواف من أسفلها. من باب الطرافة والمرح وضعته فضيلة في إحداها. صاح مختبراً صدى صوته: بَا بُو بِي!"
ابتسمت شقيقته قائلة: كنت تقول لي إن مدرس مادة اللغة العربية يحبك. الآن عرفت لماذا.
ثم نقلته إلى أعلى، حيث الرفوف الجدارية. لقد مرّ بجانب الهاون النحاسي والمدقة في قلبه، وممْلحة الطعام، وعبوة حافظة للقهوة، وكَرْتون الشاي، وإبريق خزفي، ووعاء الحليب. وكان سيمر بجانب أشياء أخرى لولا أن زُلت قدمه وكاد أن يقع فتلقفته أخته الملهوفة وأنقذته من السقوط المهلك.
قالت بلهجة حازمة: "أصغِ إلي، المطبخ مكان خطير لك في وضعك الراهِن. لنخرج إلى غرفة أخرى."
انتقلا إلى الغرفة المخصصة لإيواء الضيوف. كانت غرفة جميلة ومريحة ومزينة بالنجوم على الحائط في الجزء العُلْوِيّ منه بشكل يعطيك انطباعاً أنك تنظر إلى سماء الريف حيث لا مباني مشعة بالضوء ولا سَّوَارِي الشوارع ينتهي في أعلاها الضوء. نثرة النجوم الملصقة تمنح الغرفة: الليل وبريقه.
- سبحان الله! أنا وفي مثل هذا الحجم حينما أنظر إلى جدار الغرفة المُمْتَلِئ بالنجوم أراه كأنه حقيقة. كوكب زحل وحلقاته البرتقالية زاهٍ. كوكب المشتري يكاد تدب به الحياة وينطلق سراه إلى الجانب الآخر من الغرفة. أيْ عيني! لماذا أشعلتِ الضوء؟ لم أنتهِ بعد!
أجابت: "لا أرتاح لبقائك في الظلام لوقت طويل"، وأضافت ممعنة في تقديم حجة لرأيها الأُمُومِيّ،" الموظفة لم تنظف الغرفة منذ ثلاثة أيام، ما أدراني إذا ما ولجت فيها هامة من الهوام في هذه المدة. من خاف سلم!"
- خذيني إلى حوض السمك إذن.
- أخاف عليك.
- تخافين عليّ؟ مِن مَن؟
- من الأسماك نفسها. الآن تبدو لك مثل أسماك قرش.
- إكراماً لخاطري يا أختاه، ضعيني على اللعبة التي تتخذ شكل قارب، لأجدف.
استجابت الأخت الطيبة لرغبة أخيها المغامر، ووضعته على سطح ماء الحوض. بدأ يجدف بعود تنظيف أذن؛ لتحريك القارب. كان الحوض بعمق سبعين سنتمتر، مما أعطاه شكل البحر، فقال مخاطباً فضيلة: أتذكرين يا شقيقتي يوم ذهبنا إلى البحر ونحن صغار مع أبينا وأمنا؟ رحمهما الله.
- آمين. الله يرحمهما.
- أتذكر جيداً خوفكِ من الشاطئ. يومذاك كان البحر في حالة مد.
ضحكت فضيلة قائلة: وأنت استغللت خوفي وقمستني بالماء.
ضحك عبدالواحد إلى درجة أنه وقع على ظهره فتَهَزْهَزَ قاربه.
- يارب يا ساتر! − وقتئذ سارعت الأخت إلى نجدته وحملت القارب بمن فيه.− انتهينا من رحلة الباخرة والبحر هذي! فلنعد إلى البر.
قال عبدالواحد: أتذكرين يا شقيقتي يوم كنا صغاراً، وذهبنا إلى البر مع أبينا وأمنا. كان أبي قد اختار منطقة نائية منه. أتذكر أني ساعدت أبي في نصب الخيمة، أما أنتِ فذهبتِ لمساعدة أمي، وبدأتِ تقطعين البصل إلى شرائح. بكت عيناكِ فضحكت أمي منكِ، وانتقلت عدوى ضحكتها إليّنا أنا وأبي.
- أتذكر أنني بقيت خَجْلَى منكم لفترة طويلة في تلك الرحلة.
- وعندما حلّ المساء بدأنا نشحط أعواد الثقاب على العلبة نفسها، ونشعل الألعاب النارية.
- أذكر أننا اشترينا الألعاب النارية من البقالة التي أمام منزلنا القديم، وقالت أمي لنا: لا تزعجوا بها الجيران. العبوا بها عندما نذهب إلى البر.
- سقى الله تلك الأيام!
- والآن يكفي ذكريات، حان وقت النوم،- قالت فضيلة في لهجة أم صارمة،- سآخذك إلى المكتبة وأضعك في المنزل المُصغّر.
وهكذا انتهت تلك الليلة بالنسبة لفضيلة وعبدالواحد. ولننتقل إلى المنزل المجاور.
ما حدث مع عبدالواحد، كان قد حدث مع عبدالعزيز وتقلص حجمه إلى نفس المقاس الذي آل إليه عبدالواحد.
شَعُرَ عبدالعزيز بحرارة في رأسه وألم في قلبه وبطنه من شدة الخوف. كان يعرف أنه، مع نكبته الجديدة، ليس له سند في الحياة ولا مُعين. وقال لنفسه عندما لاح له وجه أخوه في ذهنه: هيْهاتُ هيْهاتُ أن يساعدني! ولا أريده أن يراني وأنا على هذه الحالة لئلا يشمت بي.
عبدالعزيز في صورته المُصَغَّرَة كان هيّاباً لكل شيء من حوله. أرض الفناء التي كَبُرَت بمقدار أميال وأميال، والتي كانت منذ ثوانٍ ليست أكثر من بضع خطوات قصار يتخطاها وهو غير مبالِ. والجدران التي عَلَتْ وارتفعت كأنها جبل إفرست. وأصوات أبواق السيارات في الشارع المقابل لمنزله، كأنها أبواق عماليق في القصص الخرافية. وصوت التلفزيون المنبعث من منزل قريب كأنه طبل حرب من حروب الأمم الغابرة. ظل عبدالعزيز في مكانه لا يجرؤ على التقدم خطوة أو التراجع خطوة: فلو تقدم إلى الأمام فربما تباغته وزغة أو فأرة، ولو تراجع إلى الوراء فربما تسرقه قطة شارع. قال لنفسه: من الأمان بمكان أن أبقى حيث أنا. وهكذا لزم الشاب الصغير الحجم مكانه.
أطلَ رائد من النافذة على الفناء؛ لأنه كان يعرف أن أخاه هناك، ولأنه أراد أن يعرف ماذا يفعل من باب الفضول. الحقيقة هكذا هما عبدالعزيز ورائد، يراقبان بعضهما البعض وهما في الواقع دائماً في حالة كر وفر. صُدِم رائد عندما رأى أخاه على تلك الحالة، وتملكته الشماتة وقال لنفسه: "فلأغلق الباب المفضي على الفناء كيلا يأتي إلى داخل المنزل ويختبئ فيه ويعود إلى حجمه الطبيعي. إن ثمة قطة شارع تهبط إلى أرض الفناء كل يوم. عساها تأكله وتريحني منه!".
أُطْفِئتِ أنوار الفناء وغدت الظلمة سيدة المكان. عبدالعزيز لكي يرى شيئاً وأي شيء تلزمه عينا قط. قال في حنق وقهر مكتوم: الحقير عرف! فأطفأ النور. لعنهُ الله!
بعد دقائق قليلة، صوت دبيب لقوائم أربع في الفناء. خبايا الظلمة تبتلع عبدالعزيز. إحْساسه الفَطِن يُنبئه بأن الخطر قريب وأن الموت صار أقرب من أي وقت مضى. رُفِع المسكين عن الأرض بواسطة فم القطة. لم يصرخ لأن الصراخ أحياناً يُعتبر شجاعة، وعبدالعزيز كانت الشجاعة تعوزه في تلك اللحظة المروعة. القطة عضته العضة الأولى وكان جانبه الأيسر قد سُحِقَ وما عاد قادراً حتى على التنفس. وكان الموت قد غيبه مع العضة الثانية. تداولت العضات حتى ما عاد هناك ما يؤكل من عبدالعزيز إلا اللهم دماء مراقة على الأرض ودالة على أن القطة قد ظفرت بوجبة شهية.
أنار رائد أنوار الفناء بعد ساعة، وكانت نظرات الشيطان تقطر من عينيه. تهلّل وجهه بالفرحة الظافرة القذرة عندما رأى لطخات الدماء على الأرض. وقال كَمَنْ أصيب بلَوْثَة في دماغه: أضحى المنزل كله لي! الفناء لي، المطبخ لي، المغتسل لي!..."
ولكن قبل كل شيء، يجب غسل الفناء من آخر أثر من شقيقه. كان رائد يدعك الفناء المتسخ بالدم بممسحة الأرضيات. لقد سكب الكثير من الماء والصابون وكأنه لا يريد التخلص من دم أخيه وحسب، بل محو أثره كلياً من المنزل، ومن ذاكرته، وذهنه، ووجدانه.
لقد نام رائد، بعد التهامه عشاء دسماً، وكأنه فقد كلباً جربّاً وليس أخاه.
طلع الصباح وقالت فضيلة بلهجة حنونة: عُمْتَ صباحاً أخي الغالي.
- كم الساعة؟
- التاسعة صباحا.
- أوه! إنه وقت ذهابك إلى العمل.
- لا. لن أذهب. سوف أظل إلى جانبك ريثما تزول الغمة.
- احسبي أن المسألة طالت؟
- فليكن.
- سوف تخسرين عملك.
- كل شيء يهون من أجلك عزيزي. لا تبالِ بي.
على مائدة الإفطار، كان عبدالواحد يجلس متربعاً في الصحن وأمامه شريحة خبز ضخمة بالنسبة له. كانت تكفي عشرة أشخاص من مقاسه.
قالت فضيلة: لقد طلبت من الموظفة ألا تأتي اليوم.
- لماذا؟
- من الخير ألا يراك شخص غريب وأنت في هيئتك الحالية.
نظر عبدالواحد إلى شقيقته بتقدير، وهي دائماً في محل تقدير عنده.
ارتفع الضحى، ومرت الساعات الصباحية بطيئة على عبدالواحد، لكنها مرت على أي حال. في وقت الهاجرة وبينما كانت فضيلة تعد طعام الغداء، كان عبدالواحد قد رجع إلى حجمه الطبيعي، وراح يركض يزف البشرة إلى شقيقته. تهلّل وجه فضيلة بالفرحة الغامرة ووضعت يدها على فمها: لو لو لو لو لي ي ي! (زغروطة)
بكت الأخت المحبة، وبكى الأخ المحب. ترياق الأخ من مصيبته هو حنان الأخت ولهفتها. رحِم الله من رباهما وغرس المحبة في تربة طفولتهما الصالحة فنجم عن ذلك ثمرة مباركة ونتيجة إيجابية من شجرة الأخوة. عبدالواحد قُرّة عَيْن شقيقته، وفضيلة قُرّة عَيْن شقيقها.
وفَت فضيلة بوعدها، لأن وعْد الحرِّ ديْن عليه، وأخذت عبدالواحد إلى الحديقة بسيارتها. شمَّ الشاب الزهرة، وسمع غناء العندليب، وضحكات الأطفال. تناولا غداءهم هناك، وأطعما القطط المتجولة بالقرب منهما.
قضى الاثنان عقب ذلك مساءً ثقافياً في الفناء. الإصغاء إلى الراديو وما يتيسر لهما سماعه من البث الإذاعي. ارتشاف الشاي وأكل الكعك والنظر إلى النجوم: تُخْمة الأكل، وتُخْمة التشبع بالفن النُخْبَوِيّ والفضاء. إنها النعمة المُستحقة لقلبين طاهرين.
بعد يوم، ولأن عبدالواحد يعرف مدى حب شقيقته للكون، قدم لها مِرْقَب فلكي لمعاينة الكواكب ومطالع النجوم. فرحت به كثيراً.
- هذا قليل في حقكِ ومقامكِ ومكانتكِ أيتها العزيزة الغالية،- قال عبدالواحد وقد امتلأت عيناه بدموع الحب والاحترام،- عندما يحل المساء سوف ترين الكواكب والمجرات.
السعادة غَيْمَة فوق منزل الشقيقين السعيدين، لكن لا يمكنني قول الأمر نفسه على المنزل المجاور. في مساء اليوم الذي عاد فيه عبدالواحد إلى أصله، كان رائد يشاهد التلفاز. وحينما شعر بالعطش، ذهب مسرعاً إلى المطبخ حافي القدمين؛ لأن ارتداء الشِبشِب سيضيع عليه لحظة من لحظات برنامجه المفضل. روى عطشه وأسرع يريد العودة إلى غرفة الجلوس، لكنه لم يستطع الخروج من المطبخ: تزحلقت قدماه واختل توازنه فوقع على ظهره. كانت الوَقْعة من شدتها بحيث تسببت بكسر في فقرة في عموده الفقري، الأمر الذي ألزمه البقاء في مكانه بلا حراك. حاول أن يصرخ لكن صرخاته كانت تُخرس في منتصفها من شدة الألم. حتى لفظة كلمة (آهْ) كانت توجعه وتزيد من إصابته. أضحى عاجزاً عن إيصال صرخاته المستغيثة إلى مسامع الجيران، أو أي عابر سبيل يمر بجوار باب منزله.
بينما هو مستلقٍ على ظهره وعيناه تبكيان الدموع من الوجع، دخلت القطة التي خلصته من أخيه. دخلت لأنها أتت من الفناء، ولأن الباب المفضي إلى داخل المنزل كان موارباً، لم تجد القطة عناء في التجول بداخله. كانت رائحة القمامة المنبعثة من المطبخ قد جذبتها مثلما جذبتها رائحة العجز الذي كُتِب على رائد أن يتجرع مرارته قبل أن يموت.
- لا تأكليني! أرجوكِ لا تأكليني! أنا إنسان وعندي كرامة.
وصل به الحال أن يترجّى القطة كي لا تأكله! حتى وهو عملاق بالنسبة لها. لكن القطة أرادت فقط التهام قطع عظام الدجاج التي كانت ليلة البارحة عشاءه الهانئ.
غطت القطة رأسها في القمامة وأخرجت منها قطعة عظم وولت إلى خارج المطبخ حيث غرفة نوم رائد، واختبأت تحت السرير لتنعم بغدائها اللذيذ.
كانت القطة في حالة ذهاب وإياب: من غرفة نوم رائد إلى المطبخ، ومن المطبخ إلى غرفة نوم رائد. كلما انتهت من قطعة من نفايات الطعام، تأتي مرة أخرى لتبحث عن ما يؤكل في القمامة.
خلال ذلك، كان رائد جسمه قد نحل وضعف وما عاد قادراً على الشعور بوجوده. أضحى ميتاً أكثر مما هو حي. القطة لم تقترب منه، وكأنه أحقر من أن تعضه مجرد عضة واحدة. بقي رائد في مكانه جثة ولم يعرف الجيران بموته إلا عندما فاحت رائحته. أما القطة فقد أضحت أمّاً واتخذت من تحت سرير رائد وكراً لصغارها. لم تخرج القطة أبداً من غرفة نوم رائد، وهرّت وكشرت عن أنيابها في وجه الأشخاص عندما أرادوا إخراجها بالقوة. أضحى منزل عبدالعزيز ورائد منزلها.
التعديل الأخير:








.gif)
.png)
.gif)