- إنضم
- 7 مايو 2019
- رقم العضوية
- 9955
- المشاركات
- 3,908
- مستوى التفاعل
- 4,269
- النقاط
- 585
- أوسمتــي
- 5
- الإقامة
- كوكب بلوتو ♇
- توناتي
- 355
- الجنس
- ذكر
LV
1
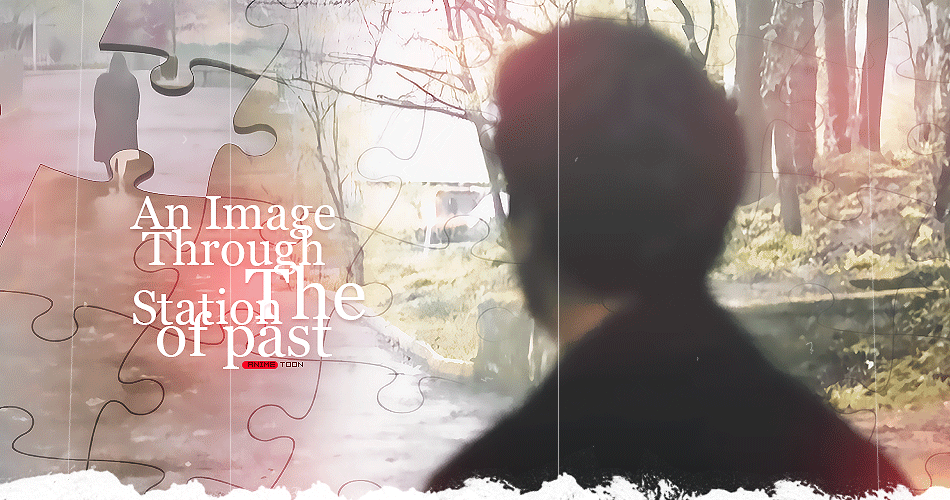

S a n d r a - F e b r u a r y
.gif)
-
- لكنَّني وَجدتُها -
[الفصل الخامس عشر]
عنوان الفصل: رنا أخرى؟
«طالبٌ غير معروف، فقد وعيه وسط الحرم الجامعي»
يا لها من نهايةٍ مُخيِّبة.
----
أردتُ بدايةً مُنصفة؛ صفحةً أمحو فيها كلّ ما كان، وأرسم نفسي كما تمنّيتُ أن أكون…
لا هذه النسخة المُنهكة مني، التي أنظر إليها الآن وكأنها غريبٌ حلّ مكاني!
«لماذا لم يُكتب لي نيل هذه الرغبة البسيطة؟ أن أكون، طبيعيًا فحسب…»
هذا الشعور الخانق… يغرس مخالبه في عنقي بعنف.
رغبةٌ مُلِحّة في محو كلّ شيء، في اقتلاع هذه الصفحة من جذورها.
فقط… لو امتلكتُ... قدرةً سحريةً ما، لدفعتُ كلّ ما أملك لأعود بالزمن، وأمسك نفسي قبل السقوط أرضًا.
كلا… بل أمنع نفسي من الذهاب إلى الجامعة يومها.
أو ربما… سأمنع نفسي من… من…
«اللعنة على هذا الحظ! اللعنة على الجميع!»
----
لامستْ وجهه لفحاتٌ باردة من النسيم، انتشلته من غرقه في أفكاره.
كان جالسًا على الأرجوحة المعدنية الصدئة، يدفّ جسده ببطء، يقبض على أسلاكها الباردة، يزيد من دفعاته في محاولةٍ يائسة لخلخلة ذلك السيل المتتابع من الأفكار.
ينتظرُ بدور في الحديقة العامة، وسط حيٍّ سكنيٍّ مهجور.
أغمض عينيه قليلًا، مستسلمًا للهواء القارس الذي يعشقه.
رغم برودة الجو، إلا أنّه كان مخلوقًا شتويًا بامتياز؛
يألف الصقيع، ويأنس للمطر، ويجد في برودتهما عزاءً غامضًا لا يعرف مصدره.
انسحبت الشمس خلف غيمةٍ كثيفة، منحته لحظة راحةٍ غير متوقّعة.
اشتدّ البرد أكثر، حتى بات يشعر بالخدر في أطراف أصابعه، وفقد الإحساس بملمس وجهه.
«لا فائدة من الشرطة، فهم يسيرون وفق القواعد، ومن يريد الحقيقة، عليه أن يخرقها بنفسه.»
كانت تلك آخر كلمات بدور أمس، حين خرجا من عيادة الجامعة، تعاود صداها في ذهنه.
–تُرى… لماذا تأخّرت بدور حتى الآن؟
تنهد بأسى، ترك الأرجوحة تهدأ تدريجيًا، فيما راح يوزّع بصره على الحديقة الواسعة والخالية؛
السماء مُثقلة بغيومٍ كثيفة ممتدّة حتى الأفق، تُزيل أيّ أثرٍ للشمس، والعشب الأخضر المبتلّ ببقايا المطر.
كانت الحديقة محاطةً بسورٍ حجري يطوّقها، ويجعلها مطلّةً على حيٍّ سكنيٍّ هادئ، يكاد يبدو معزولًا عن العالم.
لمح على الجدار المقابل قطةً سوداء، تتسلّل بخفّةٍ مألوفة، ممّا لفت انتباهه وسط صمت المكان.
قفزتْ على سقف سيارةٍ مستقرةٍ عند باب أحد المنازل.
توقّف نظره عند السيارة. أزعجه وجودها هنا؛ فهذا الحيّ ضيّق الأزقّة، لا يحتمل مرور سيارتين متعاكستين دون أن تضطر إحداهما للعودة إلى الخلف.
لم يُبنَ هذا المكان للسيارات أصلًا، وربما لهذا احتفظ بهدوئه العنيد.
«لماذا تجاهل صاحب المنزل ذلك؟»
لم يُطل التفكير، ترك السؤال يتلاشى بهدوء، وعاد أدراجه إلى قشرة أفكاره.
حتى إستقرتْ عيناه عند شجرة سِدرٍ في زاوية الحديقة.
النبق الأخضر لم يحنُ بعد على نضجه، لكن… المشهد كان مألوفًا.
في صغره، كان دائمًا ما يرشقها بالحصى لإسقاط نبقها، غير أنّ الحصى كانت كثيرًا ما تسقط في بيت جارهم العجوز، فيخرج ساخطًا يطاردهم، متّكئًا على عصاه، يلوّح بها غاضبًا.
وبعدها، كانوا يرونه من بعيد، ينحني تحت الشجرة، يجمع ما تساقط من النبق، ويضعه في كيسٍ صغير عند أبواب بيوتهم.
«أتساءل… ماذا حلّ به الآن؟»
تلاشتْ تلك الذكرى، لكنها لم تكن كافية لتفسير سبب الألفة التي يشعر بها.
في تلك اللحظة, شد انتباهه شيءٌ آخر.
عند الطرف المقابل من الحديقة، قرب الشارع، لمح رأسًا يطلُّ من خلف السور الحجري، يراقب المكان بحذرٍ مريب، كجاسوسٍ في مهمة لا تحتمل الخطأ.
قبعة سوداء، نظارةٌ شمسية تخفي معظم ملامحه، وسكونٌ مريب.
راقبه لثوانٍ، قبل أن يخرج من مخبئه ويقترب بخطواتٍ مترددة، حتى اتضح الأمر؛ ذيل حصانٍ منسدل من تحت القبعة، وقوامٌ أنثويٌّ رشيق، كانا كافيين لفضح التنكر.
«ما الذي تفعل هذه بالضبط؟»
ترتدي زيًّا رياضيًّا أسود، بجاكيت فورميلا مميز يشي بأنها في أوائل العشرينات.
وحين اقتربت أكثر، قال أحمد بفتور:
– أحقًا؟
– هاه… لم تعرفني! «نزعت النظارة والقبعة بحركة مسرحية وقالت بغرور» أليس كذلك؟ كنت أعلم أنك أحمق.
– نعم صحيح، «سايرها بابتسامة مصطنعة» أنتِ بارعة فعلًا.
دمدم في نفسه: «لو كان هدفكِ التخفي، فأنتِ فاشلةٌ في ذلك بامتياز»
– ماذا قلت؟ «صرختْ بغضب»
– لا! «قال بابتسامة» لم أقل شيئًا…
رمقته بنظرة حادة، كتهديدٍ صامت.
كان مظهرها غريبًا، كأنها هاربة من أحد أفلام الجواسيس.
سترة رياضية بجلدٍ أسود، منقوش عليها شعار حصانٍ أصفر مزخرف بأناقة، وبنطالٍ الداكن، منحها طابعًا مغامرًا.
ورغم ذلك، لم تفقد جاذبيتها. كانت جميلة بطريقة عصرية، تعرف تمامًا كيف تختار ما يُبرزها.
– وما الهدف من ذلك يا «لارا كروفت»؟
رمقته ببرود وقالتْ:
– نحن نتعامل مع مجرمٍ محتمل. «أعادت القبعة إلى رأسها وأكملتْ» لا أريد أن أنتهي مقطعةً في سلة قمامة.
انقبض قلبه عند سماع ذلك. تسللت صورة آدم إلى ذهنه، كما عرضها له المحقق. ذلك الوجه المشوّه لم يفارق ذاكرته منذ ذلك اليوم.
«ربما.. سأشتري نظارة وقبعة أيضًا»
جلستْ على الأرجوحة المجاورة له وبدأتْ تدفع نفسها بحماس.
لم تنطق بشيء، سوى ضحكات مرحة.
وبعد لحظات، قال أحمد، متشبثًا ببصيصٍ من الأمل:
– إذًا… هل لديكِ خطةٌ ما؟
خففت من تأرجحها:
– همم؟ أيُّ خطة؟
– ماذا؟ «قال بنفاد صبر» حين قلتِ إننا سنكشف الحقيقة، ألم يكن في بالكِ شيء؟
صمتت لثوانٍ، تحدّق في الأرض، ثم قالت بنبرة باردة:
– لا. لا أملك خطة.
شعر بانطفاء آخر شعلة داخله. الأمل الذي بناه طوال الليل، تهدّم دفعةً واحدة.
لم تكن كلماتها ما أسقطه؛ كان قد سقط فعلًا…
هي فقط، أزالت الشيء الوحيد الذي جعله يظن، لثوانٍ، أنه ما زال واقفًا.
في داخله، كان المكان موحشًا، لا يرى إلا الظلام، وذلك الكيان المظلم الذي يراقبه بصمت. ثُمَّ رأى يدًا تُمد له، تكسر ببريقها ظُلمة المكان.
كانت تشعر بما يشعر، متعاطفةً معه، لا تنصح ولا تنفر، بل كانت تريد المساعدة حقًا!
كان قد ظن – بسذاجة – أنها قد تعرف شيئًا أكثر مما تُظهر، أن عرضها للمساعدة.. لم يكن عبثيًا!
لذلك شعر… بالراحة، أنها ستكون طوق نجاته الأخير.
«ما الفائدة من كل ذلك؟»
ها هو الآن يعود وحيدًا. كان أملًا زائفًا، تشبث به كي يهرب من هذه الظلمة الحالكة.
رمقها بنظرة جانبية، كانتْ تحدّق بشجرة السدر البعيدة، مبتسمةً بهدوءٍ غريب. بدتْ مختلفة بطريقةٍ ما. كانت… بعيدة. غير موجودة هنا.
لم يعد يعلم ما يفعل، بل ما الذي يفعله. «لماذا نحن هنا أصلًا؟»
بدأ رذاذٌ خفيف من المطر يهطل، يتطاير مع النسيم البارد.
عاد ذلك الشعور المألوف؛ نوبات الحزن التي تستحضر كل المآسي السابقة.
لكن بدل الحزن… شعر بالخجل.
صوتٌ داخلي يصرخ: «ما تمر به تافه.»
بجانب هدوء بدور الغريب، كان يرى نفسه طفلًا نكديًا، يريد الحصول على لعبته بأي ثمن، وبدور تحاول قدر المستطاع أن تسكته وتسايره كي لا يبكي.
شعر بالخجل لأنه انتظر تعاطفًا.
«ربما لا أحتاج قبعةً ونظارة بعد الآن.»
الانتهاء مقطعًا في سلة قمامة قد لا يحدث لي، لكنه حدث لآدم…
لكن، لا يزال ذلك الخوف يطاردني، ليس من الموت، بل من نفسي. من حقيقة أنني لا أشعر بالحزن إلى الآن، هذا يشعرني بالذعر.
بعد وفاته مباشرة، ذهبتُ إلى الجامعة كأن شيئًا لم يكن. بينما كان الجميع متوترًا وحزينًا في مكانٍ تسيطر عليه الكآبة، ذهبتُ لأشتري من النادي قهوة بالكراميل!
– هل تعرف أسطورة القمر، أحمد…؟
-م.. ماذا؟
استغربتُ سؤالها المفاجئ، لكنّه مرّ على مسامعي كنغمة مألوفة قديمة، قبضتْ قلبي وسحبتني إلى ماضٍ بعيد.
لم تكنْ أسطورة القمر تخصنا أنا ورنا فقط، بل حكاية شعبية ترويها الجدات للأحفاد بعد العشاء، عند انقطاع الكهرباء، عندما يجتمع كل الأطفال حول شمعة صغيرة.
كنا متحمسين لرؤيتها، نصدق وجودها. لقد رأيناها، أجل! لا أعلم إن كان ذلك حقيقة، أم محض خيال طفولي.
– بالطبع، ومن لا يعرفها؟ «قال متصنعًا الاستغراب»
– سمعت من أبي ذات مرة أنها حقيقية.
– أجل، هذا ما كان يقولونه لنا.
– نعم… لكنّه فسر لي ذلك بطريقة غريبة لم يستوعبها عقل طفلة صغيرة حينها.
– حسنًا… وماذا قال والدك؟
– امممم… لا أذكر بالضبط… لكن…
كان يراقبها باهتمام وهي تنظر إلى الأرض، ثم رفعت بصرها إلى السماء، ابتسمتْ:
– عالم موازي.
– ماذا؟
– أجل، كما سمعتْ.
تدفع الأرض بطرف حذائها، تبرم الأرجوحة حول محورها بحركات دائرية لتعتصر الاسلاك فوق رأسها بقوة، ثم اكملتْ قائلة:
-هناك نظرية تقول إننا لسنا وحدنا في هذا العالم. توجد أكوان أخرى، فيها نسخ مطابقة منا تمامًا.
سكتتُ قليلًا، أحاول البحث بين كلماتها عن معنى لهذا النقاش:
– إذًا تقولين… أن هنالك نسخة أخرى من كل واحدٍ منا؟
– هذا ما تقوله النظرية.
افلتتْ قدمها لتدور بحركة لولبية سريعة.
دمدمتٌ في نفسي:
– أعتقد أن نسختك الأخرى ستكون عقلانية أكثر منك.
– وربما نسختك الأخرى ليستْ بكّاءةً مثلك.
أغاضني ردها، لكن لم أحاول مجابهتها بالجدال.
– بدور، ما بك؟ أسطورة القمر، ثم العوالم الموازية؟ «أردفتُ بارتياب» ما نوع الغداء الذي تعاطيتِه اليوم؟
نظرتْ إلي مبتسمة بهدوء، كأنها كانت تنتظر هذا السؤال:
– حسنًا… يُقال إن أميرة القمر، هي في الحقيقة… ليست من القمر.
– وكيف ذلك؟
– إنها من مكان بعيد جدًا، كونٌ موازٍ لكوننا هذا، ولها قصة شاعرية حزينة أيضًا.
أشحتُ بوجهي عنها متمتمًا بقلة حيلة:
– كل ما يقال عنها ما هو إلا أساطير، لماذا تتحدثين وكأنها حقيقة؟
– لا يهم وجودها من عدمه، لكن فكرة أن هنالك نسخًا أخرى لا متناهية مني… تجعلني أرغب بلقاء أحداها حقًا!
– وماذا ستفعلين حينها؟
– ماذا سأفعل؟ اممم… لا أعلم.
– أنتِ غريبة حقًا «قالها وهو يمطُّ ذراعيه بكسل» تقولين إنك ترغبين بلقائها ولا تعلمين لماذا.
– ربما… سأكرهها، لأنني سأعرف بما تفكر، وأنا بصراحة لا أحب طريقة تفكيري.
– هذا… غريب.
– وأنت؟
– ماذا؟
– ألم تفكر بذلك من قبل؟
– لا أشعر باهتمام تجاه هذا النوع من الأفكار.
– ماذا؟ «قالتها وهي تميل برأسها بـحنق» أنت ممل حقًا.
سلمتْ نفسها لحركة الأرجوحة الرتيبة، تذهبُ وتجيءُ كبندولِ ساعة، وهي تقول:
– أما أنا، فقد أخذتُ هذه الفكرة إلى مستوى آخر.
– وكيف ذلك؟
لم تجب عن سؤالي فورًا، تدفع نفسها بقوة أكثر فأكثر، تستمتع بوقتها كطفلة صغيرة. كان ذلك يغيضني.
بعد لحظات، خففت سرعتها ثم قالت وهي تلهث:
– ماذا إن… ماتت رنا في عالمنا هذا، وبطريقة ما، استطعنا أن نسافر إلى كونٍ موازٍ وجلبنا نسخة رنا الأخرى، ماذا كنت ستفعل حينها؟
– ما هذا السؤال الغريب؟
ابتسمتْ بدور، ثم نظرت إلي وقالت بلهجة قاطعة:
– هل كنت ستحبها، أم لا؟
----
بعد أن أدركتُ الأمر، سقط سؤالها في داخلي كضربة صامتة، فتح أبوابًا لم أجرؤ يومًا على طرقها.
رنا… نسخة أخرى من رنا؟ نسخة عاشت كل ما عاشت هي… هل كنت سأختارها؟ أم سأراها مجرد غريبة تشبه الفتاة التي أحببتها يومًا؟
ارتعشت أفكاري، تلاعبت بي احتمالاتٌ لا أريدها:
إذا اخترتُ النسخة الأخرى… هل هذا يعني أن حبي لها لم يكن حقيقيًا؟ مجرد حبٍ لشكلها، لقالبها الذي رسمته في مخيلتي؟
وإذا لم أخترها… فكيف أفسّر حينها حبي حينها، وهي نفس الفتاة التي عرفتها منذ الطفولة؟
كل خيارٍ يجرحني، يكشف ضعفي…
لم أعد أستطيع التمييز بين ما هو شعور حقيقي، وما هو وهم.
هل أحبُ رنا حقًا؟
----
وقبل أن أنتزع إجابةً من وسط ذهولي، قطعتْ بدور حيرة صمتي وقفزت من الأرجوحة برشاقة، كأنها تسحبُ معها بقايا سؤالها وتفرُّ به بعيداً تاركةً المقعد الخشبي يتأرجحُ خلفها.
قالتْ وهي تنفض ملابسها من الغبار:
– هل ننطلق الآن؟
– إلى أين؟
التفتت إليّ، تقف باستقامةٍ واثقة وهي تدسُّ يديها في جيوبِ الجاكيت، ثم قالت بابتسامةٍ مشرقة بدت لي كأنها تعيدُ ترتيب العالم من حولي:
– إلى المكان الذي وجدوا فيه جثة آدم.
صُعقتُ مما سمعته، فذلك آخر مكانٍ أرغب في زيارته.
– أأنتِ مجنونة؟! «صرختُ قائلًا» ماذا سنفعل هناك أصلًا؟
– أنت أحمق، «أكملت ببرود» لقد قررتُ مسبقًا الذهاب إلى هناك، حتى قبل أن أزورك في المشفى.
– لكن.. «قُلتُ مذهولًا» الشرطةُ لم تترك زاويةً هناك إلا ونبشتها، ما الذي سنضيفه نحن بحدود ما نعرفه؟!
– الشرطةُ لها حدودها، ونحن لسنا شرطة.
تجمّد لساني. لم أعد أعلم ما أقول. هل هذه الفتاة تعلم ما تفعل؟
لكن، رغم ذلك… عاد إليّ بصيصٌ من الأمل. فنبرتها الآن توحي بأنها تعرف شيئًا حقًا، وليس مجرد حدسٍ عقيم، فما كان مني إلا الإيماء بالموافقة.
– وشيءٌ آخر، «قالت بصرامة» إن نعتّني بالمجنونة مرةً أخرى… سأحطّم أسنانك السفلية. مفهوم؟!
... يتبع ...

التعديل الأخير بواسطة المشرف:







